-
 الظلم ظلمات
الظلم ظلمات
بقلم : زينة محمد الجانودي
الظلم لغة: وضع الشيء في غير موضعه، وهو الجور، وقيل: هو التصرّف في ملك الغير ومجاوزة الحدّ، ويطلق على غياب العدالة أو الحالة النّقيضة لها. ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى حدث أو فعل معيّن، أو الإشارة إلى الوضع الرّاهن الأعمّ والأشمل.
الظلم دليل على ظلمة القلب وقسوته، وهو من أبشع الصّفات، وأقبح الأمور الموجودة في حياتنا، كما أنّه من أعظم المعاصي وأشدّها عذابا، وأبغضها عند الله، { ألا لعْنَةُ اللّهِ على الظّالمينَ}[ سورة هود، آية :١٨]، { واللّهُ لا يُحِبُّ الظّالمينَ}[ سورة آل عمران، آية :٥٧]، {إنّ الظّالمينَ لهُمْ عَذابٌ أليمٌ}[ سورة إبراهيم، آية:٢٢].
وبواعث الظلم تتكوّن من مصادر شتّى، كالعداوة والكره، والحسد والطّمع، وله أنواع وصور عديدة منها:
_ظلم الإنسان نفسه: وذلك بإهمال توجيهها وتقويمها، ممّا يزجّها في متاهات الغواية والضّلال، فتبوء آنذاك بالخيبة والهوان، { فمنهُمْ ظالمٌ لِنَفْسِهِ}[ سورة فاطر، آية ٣٢].
_ظلم الإنسان لغيره: وذلك بالعدوان على غيره، قولا أو عملا، إن كان بالمالوبخس الحقوق،أو إساءة المعاملة والتعسّف، أوالاستخفاف بالكرامات والاستعلاء.
ومن أبشع المظالم هو ظلم الضّعفاء، الذين لا يستطيعون صدّ الظلم عنهم، ولا يملكون إلا الشّكوى والضّراعة إلى العدل في مظالمهم.
_ ظلم الحكّام والمتسلّطين: بقدر ماعرف التاريخ حكّاما عادلين أدّوا هذه المسؤولية الجسيمة بأمانة، بقدر مابرز حكّام آخرون استغلّوا سلطتهم، وطغوا في البلاد فعاثوا فيها فسادا واستبدادا وظلما،فجعلوا معيشة شعوبهم ضنكا،فخنقوا حريّاتهم وانتهكوا كراماتهم، وابتزوا أموالهم وسخّروها لمصالحهم الخاصّة، من أجل ذلك كان ظلم الحكّام أسوأ أنواع الظلم وأشدّها نكرا، وأبلغها ضررا على كيان الأمّة وقدراتها.
وعندما نتكلّم عن الظلم والظالمين والمستبدّين، لابدّ لنا أن نتكلّم بالمقابل عن هؤلاء المتفرّجين السّاكتين عن ظلم الظالم، عملا بمبدأ " لا شأن لنا طالما كان بعيدا عنا"، فهم لا يعلمون أنّ آليّة الظلم والظالمين، تعمل على أساس أنّ الجميع مستهدفون، لذلك يخطئ من يظنّ أنّ الظلم الواقع على غيره لن يصل إليه، فعندما يفرغ الظالم من إيقاع الظلم على الآخرين لا بدّ أن يطال بظلمه من أعانه عليه، سواء بالسّكوت والرّضا، وغضّ الطّرف، أو بالعمل والقول، كما أنّ الظالم لم يكن ليتمادى في ظلمه وطغيانه، إلّا بسبب هؤلاء المتفرجين السّاكتين، فقد درج الأمر على أن يتّجه الغضب واللّوم إلى الظالم والمستبدّ دون أن نتعرّض لهؤلاء الذين قويَ الظالم والمستبدّ بسكوتهم وتشرذمهم، ولو اعتبرنا الظلم منكرا فأنكرناه بيننا، وغيّرناه بقلوبنا، وساهمنا في تغييره بألسننا، ثمّ تعاونّا على تغييره بأيادينا، لما طغى الظالم، ولكن ربّما الخوف قد سيطر على مجتمعاتنا منذ عقود وقرون، وربّما طغت المصالح الفرديّة للناس على فطرتهم في الدّفاع عن المظلوم والوقوف معه ضدّ الظالم، وربّما أصبحت مصالح الناس، تُقْضَى عند من يعرفون أنّه ظالم دون قدرتهم على الإقرار بذلك، وربّما قد يعتبر الظالم مظلوما، والفاسد المفسد صالحا ومصلحا، نتيجة لسياسة تضليل الرّأي العام، وترويج المغالطات، والتعتيم على أصحاب الحقّ.
ولكن كلّ هذه الوقائع والأحداث، لا ترفع عنا الحرج ولا تعفينا، من مهمّتنا ودورنا في فضح الظالم، ولكن فضحه لا يعتبر أخذا بكامل الحقّ، ولا يُسْقِط المطالبة به، إذ لابدّ من مواجهته بهدف القضاء على الظلم والطغيان والحدّ قدر المستطاع من انتشاره.
إنّ المنطق ليس أن نحصر أنفسنا بين اختياريْن، وهو إمّا أن نكون مظلومين أو ظالمين، فالصّحيح أن يكون هناك اختيار ثالث، وهو أن يحصل كلّ صاحب حقّ على حقّه، فلا يكون هناك ظالم أو مظلوم، وصحيح أنّ الأديان نبذت العنف وتبّنت السّلميّة، ولكنها لم تدعُ إلى الرّكون للظلم وقبوله، مخافة الدّخول في صراع مع الظالم، لأنّ الأديان نزلت كثورة ونهضة تدعو إلى الحقّ والعدل والمساواة، وعدم الضّعف والخنوع بوجه الظالم، وإنّما التحلّي بالقوّة لقول الحقّ والتّضحية لنصرة المظلوم، ومحاسبة الظالم على ظلمه، ولكن عندما تُحوّل الأديان ورسالتها الحقيقيّة إلى مؤسّسات، تُدار في خدمة السّلطات، ويستغلّ بعض رجال الدين تقديس الناس لهم، كي لا يناقشونهم ويقيّمون أفعالهم، فهنا لا يمكن تحقيق دعوة الأديان وثورتها ورسالتها ونهضتها، وبالتّالي سيتقبّل الناس الظلم، ولا يتحرّرون من الظلم والاستبداد.
الظّلم ظلمات، وهو كالسّرطان الذي ينتشر في الجسد، وقد لا يدرك المرء وجوده إلا بعد أن يبلغ مبلغا لا نجاة فيه من هلاك محقّق، فما من شيء أخطر على المجتمعات من تفشّي الظلم فيها، فالظلم مهلكة للأفراد كما للدّول، ولا يمكن أن يتحقّق استقرار الشًعوب، ولا يمكن أن يتحقّق إنماء وازدهار وعمران البلاد، إذا اختلّت موازين العدل وعمّ الفساد، وتحكّم الأقوياء في رقاب الضّعفاء، وتصدّر المفسدون في واقعنا الذي نعيشه.
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة رفل في المنتدى منتدى عراق الخير للعملات
مشاركات: 6
آخر مشاركة: 07-15-2016, 05:23 PM
-
بواسطة فراس حمزه في المنتدى منتدى عراق الخير للعملات
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 03-01-2016, 08:22 PM
-
بواسطة ياسمين الورد في المنتدى منتدى عراق الخير للعملات
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 02-29-2016, 12:47 PM
-
بواسطة ام هبه في المنتدى منتدى عراق الخير للعملات
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 08-23-2014, 12:52 PM
-
بواسطة كاظم المسعودي في المنتدى منتدى عراق الخير للعملات
مشاركات: 6
آخر مشاركة: 08-05-2014, 05:44 PM
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى
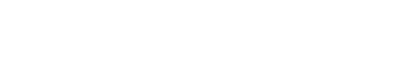








 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
المفضلات